تفاحة آدم
خطاب إلى حواء
كنتُ يا حواء – قبل أن تُخلقِي – ملكا في جنّتِي ، و ملكي لا حدود له ، ولا منازعَ ينازعني فيه ، وما كان مُلكي – على رحابته واتساعه – ليشعرني بالوحدة أو الوحشة ، بل كنتُ منعدم الشعور. فأنا لم أُحرمْ شيئا لأشعر بالحرمان ، ولم أنل شيئا كنتُ قد حُرِمتُه لأشعر بلذةِ ما حرمتُ منه ، فقد سبقت النِّعمُ خلْقي وبعد خلقي نلتُ كلّ شيء ، ولو قدِّر لي أن أشعر حينها لم أكن لأشعر بغير الأنس بالقرب ممن أسبل علي تلك النعم و وهبني تلك الجنة أتبوأُ منها حيثُ أشاء.
وحدي أسير وسط ذلك الملك العظيم أتقلبُ بين جناته وبساتينه ، أمدُّ يدي و لا أنظر إلى ما مددتُ له يدي لأنني كنتُ أعرف أن يدي أنَّى وقعتْ ستجني ثمراََ ولن ترتدَّ إلا بأطيب و أشهى الثمر ، ولم أكن أشفقُ أو أخشى على ما ستقطفه يدي الممتدة ، فقد تعودتُ أن تلك الثمار تثمرُ من جديد قبل أن تصل إلى فمي ، لأن الزمن - على أزليته واستمراره هناك – كان معدوما ولا سلطان له على جنتي.
وإن أحسستُ بالظمأ فما علي إلاّ أن أطأطئ لأشرب من أنهاري الجارية تحت قدمي وسيان عندي أشربتُ لبناََ أم ماءََ ، خمراََ أم عسلاََ ، فطعم اللبن كطعم الماء ، وطعم الخمر كالعسل ، ولأنني لم أكن أفكر في هذه الأشياء لوفرتها فقد كان شعوري فردوسياََ وتفكيري ملكوتياََ يتجاوز حدود الجنان و يصبو إلى عرش الرحمان.
كنتُ يا حواء – قبل أن تخرجيني من جنتي – أعيش كما أشتهي وبما يوافق هواي و يرضي مزاجي ، كانت حياتي مزاجية لا يعكر صفوها شيء ، بعيدة عن التفكير وحسابات النتائج و العواقب ، ليس هناك قانون يقيدني ويحدُّ من حريتي ، أو شريعةُُ تملي علي ما أفعل أو تفرض علي واجبات وتمنحني حقوقاََ ، بل لم تكن هناك محذورات ولا ممنوعات ، فكل شيء موجود هو جزءُُ من ملكي أتصرف فيه كيف أشاء دون رقيبِِ أو عتيد.
كانت جنّتي كاملةََ غير منقوصة ، وكان ملكي واسعاََ لا شيء ينقصة ، حتى الألحان لا أسمع إلاّ أشجاها وكل ما كان علي فعله هو الاستلقاء تحت أقرب شجرة مني و أصغي إلى طيور جنتي وهي تعزف أوتارها و تغني أعذب الألحان بأجمل الأصوات.
تعرفين يا حواء ؟ وسط كل هذا النعيم المقيم راودني ذات مرة شعورُُ غريب ، بأن شيئا ما ينقصني بم أكن أستطيع تحديده أو تسميته ، أقلبُ فكري لأعرف ماهية هذا الشيء و أدرك كنهه فأعود كليل الفكر عاجزاََ عن إدراكه.
ربما شعوري بالسلطة المطلقة جعلني أتساءل لو أن أحدا يشاركني هذا الملك و ينعم معي بهذا النعيم ، أكان سيجعلني أكثر سعادةََ أم يسلبني أشياء هي الآن ملكُ يميني ، وهل أن ما أملك هو كل شيء أم أن هناك أشياء أخرى أفضل لم أعطَها و لم أطلع عليها؟!.
أي رغبةِِ تلك التي تناديني و تجعلني أشعرُ بافتقاري لها رغم السعادة التي أتقلبُ فيها ؟!.
ظللتُ هكذا حتى تعبتُ و أنتفخ رأسي من كثرة الأسئلة إلى أن استولى علي النعاس فغفوتُ لبعض الوقت.
ولما فتحتُ عيني وجدتكِ إلى جانبي ؟ ! وبعفويةِِ غريزية هممتُ بكِ دون أن أحاول معرفة ما تكونين ، وكيف جئتِ ولم أكد أفعل حتى سمعتُ صوت ربي يناديني : توقف أبعد يدك ؟! .
فقلتُ: ولكن يا ربي لماذا تمنعني وأنت الذي وهبتني كل شيء ؟! أليس هذا بعضا من نعيمك الذي أتقلبُ فيه ؟!
قال: بلى ولكن هي لن تكون لك إلا بحقها.
قلتُ- وقد بدأتُ أشعر بما لم أكن أشعر به من قبل من المحذورات – وما حقها ؟!
قال: أن تشهد أن لا إله إلاّ الله و أن محمداََ رسول الله.
هنا عادت بي الذاكرة إلى ذلك اليوم الذي رأيت فيه اسم محمد على باب الجنة قبل أن أدخلها وقد كتب إلى جانب اسم الله مقروناََ به ، فتساءلتُ حينها : ولكن ما هذا الاسم الذي قرنته باسمك يا ربي ؟!
يومها أجابني قائلاََ: هذا أحد أبنائك و أكرمهم يجيء من ظهرك و نسبك.
فاستغربتُ و لم أدرك معنى ما قاله ، و كيف لي أن أدرك حينها و أنا مخلوق وحيد لم أر شيئاََ غيري إلا ما رأيتُ من الملإ الأعلى.
ولما ثبتُ إلى رشدي نطقتُ بالشهادتين ، وكان أول واجبِِ أقوم به منذ عرفتُ الحياة، وأبصرتْ عيني النور و أدركتُ ساعتها بأنكِ مخلوقُُ غير عادي وسيكون لي معك شأنُُ عظيم. كما أدركتُ مدى قداسة العلاقة التي ستربطنا ، - وكيف لا- وصداقها نطقُ الشهادتين بأجل و أعظم اسمين.
ثم تفقدتُ نفسي بعدما أحسستُ أنني قد فقدتُ بعضا مني و نظرتُ إلى جنبي الأيسر لأقف على كنهكِ وسر وجودك وأعرف سبب رغبتي فيك وميولي إليكِ وانعطافي نحوك.
منذ تلك اللحظة أصبحتُ لا أطيق الابتعاد عنكِ وكلما ابتعدتِ يضيق صدري و أشعر بالوحدة و الوحشة و ما كنت أشعر بهما من قبل ، وعندما أجدك يطمئن قلبي و تهدأ نفسي و أجد الراحة والأنس ، وكيف لا و أنت ذلك الضلع الذي قُدَّ مني ، ولطالما جاور قلبي و ارتوى بدمه فأخذ بعضا منه ، كيف لا و أنت جزء من كلّي ، والكل لا يتجزأ ، فلا عجب إذاََ أن أبحث عنكِ أو بالأحرى أبحث عن نفسي كلما فقدتك واشتق إليك في بعدي عنك و آنس بالقرب منك.
و ها أنت ذي - بعد أن أدركتِ ذلك – أصبحتِ تتعمدين الابتعاد عني والاختباء مني و كأنك تستمتعين بسعيي وراءك في جنتي على اتساعها و كثرة الأمكنة التي يمكن أن أجدك فيها . وكنت في كثير من الأحيان أفقد الأمل في العثور عليك ، ولكن ذلك لم يكن ليمنعني عن الاستمرار في البحث عنك حتى بعد مرور عدة أيام .
أصبحتِ شغلي الشاغل استحوذتِ على تفكيري وشعوري دون سائر النعم ، جعلتني – يا ضلعي الأعوج – أعرف معنى الوحدة و الوحشة عندما أفقدك و الأنس و السكينة حين أجدك.
أجبرتني على السعي من أجل تحصيل شيء ما و أنا الذي كنتُ أنال الأشياء دون سعي أو تعب ، أليس ذلك غريبا ؟! .
لا ، في الحقيقة لم أكن أستغرب ذلك.
لأنني عندما أقلبُ الأمور على وجوهها و أرجع الأسباب إلى المسببات أجد أنها محصِّلة معقولة و نتيجة حتمية لِما تقدم.
إنها - يا حواء- رحلة البحث عن الذّات أو بحث الكل المبتور عن الجزء المبتور منه ، أو ما نسميه اليوم ( النصف الآخر ) .
لكن الذي استغربه من كل هذا هو تساؤل الناس اليوم عن معنى الحب وسر وجوده و لماذا نشعر به ؟! و الإجابة من البساطة و السهولة ما يجعل هذا التساؤل سؤالا غبيا بل و أحمقاََ.
لأن الجزء المفقود - حتى و إن كان ضلعا أعوجا – فيكفي مبررا أنه قد أنتزع من جهة القلب الذي هو مستودع العواطف و مستقرها ، فلماذا إذاََ يتعبُ الخلق أنفسهم في فهم شيء من المسلمات كعاطفة الحب؟ ألا يعلمون أن كلا منهم شق مائل لا يستقيم إلا بالشق الآخر ، وأن جزءاََ منهم تجسد في مخلوق حي اسمه – حواء – و أودع أمانةََ في خلقها ؟!.
آدم يا حواء – الذي هو أنا – أو بالأحرى أنا – يا حواء – من أدرك سر علاقتنا لأنني يومها اشتهيتكِ و أردتكِ
و آدم اليوم يحبك و يهيم بكِ ، وشتان بين الاشتهاء و بين الحب.
و ها أنا الآن - مع بدأت أعانيه معكِ في جنتي – أصبحتُ أراك ذلك الضلع المتمرد عن أصله أو شهوة متمردة لتعود بي الذاكرة إلى ذلك اليوم المشهود – يوم خلقي – عندما أمر الله ملائكته أن يسجدوا لي ، ولم أكن ساعتها أعي شيئا مما يحدث حولي ، وكنتُ أشعر بأن شيئا عظيما يحدث.
سجد الملائكة كلهم إلا إبليس أبى، وحدث نقاش هو أقرب إلى الاختصام منه إلى الحوار ، لكن ما يجعله حوارا هو جلالة قدر الله بأنه الخالق و مهما علت درجة إبليس إلى الملائكية فإنه يبقى مخلوقا بأمر لا يعدو المسافة الفاصلة بين الكاف و النون.
لكنه لجهله نسي هذا الأمر و تطاول على خالقه الذي قال له كـــــــــــــــن ، فكان .
ولولا رفعةُ مكانتي و عظمة شأني ما كان ليحدث كل ذلك الحوار وتلك المجادلة ، و ما كان ربي ليقحم نفسه في خصامِِ من أجلي ؟!.
رجعت بي الذاكرة إلى تلك اللحظات الملكوتية العصيبة ، فلم أعد آبه لتمردك ، مادام ذلك المخلوق التافه التعيس – مع ما ناله من مكانةِِ عظيمة عند ربه – تمرد على خالقه - بعظمته وجلاله – و عصى أمره ، فكيف لا يتمرد ضلعُُ ( أعوج ) و شهوة وضيعة على صاحبها و جزء قليل على كله.
رغم كل ما حدث فإن الخالق تعالى وترفع عن ذلك المخلوق المسكين الذي لم يكن يعلم بأن الله خلقني لأكون سببا مقنعاََ لإخراجه من رحمته لما علمه من عدم صفاء سريرته و صدق طاعته الظاهرة ، فتركه على سجيته و أمهله إلى يوم القيامة لأنه يعلم بأنه سوف يأتي عليه يوم ويشعر بالندم و يتمنى لو أن ما حدث لم يحدث.
وفعلا فقد حدث ذلك ، إذ ورد في الأثر بأن إبليس طلب العفو من خالقه و أراد أن يتوب من ذنبه فتوسط لديه بأحد الأنبياء فاشترط عليه ربه أن ينفذ أمره و يسجد لي ، بعد مرور قرون عدة على خلقي ، لكنه – ولحمقه – رفض الأمر مجددا بقوله: إلاَّ هذا ؟! وبقي مصرا على ضلاله و معصيته.
فيا حواء....
يا ضلعي الأعوج: تمردي كما تشائين ، ويا شهوتي استبدي كما تريدين و يا جزئي تعالَيْ كما تحبين ، لأنك مهما تمردتِ فإلي تعودين ، ومهما استبديتِ ففي شهوتي تموتين ، ومهما تعاليتِ ففي كلي تذوبين.
فقد كنتُ أحيا و حياتي خلودا لا نهاية له ، وأنعم و كان نعيمي أزليا ، و كنتِ بعضا من ذلك النعيم أو ظننتكِ كذلك.
عندما كنتُ أبحث عنكِ كان يتملكني الخوف من أن يغويك ذلك المخلوق المتمرد ، لأن ربي لم يحذرني من تلك الشجرة عندما كنتُ وحدي ، ولم أعرف المحذورات إلا بعد ما أوجدكِ ، و كأنما قد أوجدها معكِ ، أو جعلك مصدرا لها و سببا للكثير منها ، وقبل كل شيء أصلها و مبدؤها، لأنه لا وجود لشيء قبل وجود أصل له و مبدء يبتدئ منه غير الله سبحانه و تعالى جل عن الشيئية.
ولن أنسى ذلك اليوم عندما وجدنك مع ذلك المخلوق و هو يزين لكِ الأكل من تلك الشجرة و يمنيك الأماني ، ولأن عقلي كان يبحث عن جديد يجعله يفهم أكثر و يستوعب ما حوله من الموجودات ، جعلتُ أتأمله و استمع لحديثه ، ولم أكن أعلم بما يبيته لنا.
لكن سلاسة لسانه وسحر بيانه – وهو المخلوق القديم صاحب الخبرة و الدهاء – غطى على بصيرتي و أدهش عقلي حتى كدتُ أميل إليه ، لولا تذكري لتحذير الخالق منه ، ولكنكِ يا حواء لم تشهدي ذلك اليوم العظيم – يوم السجود – يوم الملإ الأعلى إذ يختصمون . لذلك لم يكن لديك تحفظ من جهته ، فدخلتِ في غمرته ، ولفرط فضولي بدأتُ أتساءل عن سبب تحذير الخالق لنا من الشجرة التي لم أنتبه لوجودها من قبل ، إلا أنها أنها إحدى المحذورات التي عرفتها معكِ.
وكأن إبليس علم ما بنفسي ، فلم يفوت تلك الفرصة لينصب لي كمينه بقوله: (( مَا مَنَعَكُمَا رَبُّكُمَا مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخَالِدِينَ )). صدق الله العظيم
هنا طار لبُّكِ وذهب عقلك و غابت عنك الحكمة و خانتك البصيرة ، فمددتِ يدك و تناولتِ تفاحة و أكلتِها بكل برودة ، وأردتِ أن أشاركك أكلها فأغريتني بحلاوة طعمها و لذة مذاقها . و لم أكد أبتلعها حتى سمعتُ صوت ربي يناديني فأفقتُ مذعوراََ وأنا لم أبتلعها بعد.
مر علي يوم عانيتُ فيه لحظات عصيبة ما زالتْ صورتها في نفسي ، والندم عليها يأكلني حتى اليوم، وعارها يطاردني في يقظتي و منامي ، وعندما أتذكرها أرى نظرات ربي الغاضبة و سحنته المتجهمة ، وسرائر إبليس المبتهجة المليئة بنظرات البِشرِ و الاستهزاء ، و فرحة الظفرِ و الانتصار.
حتى وجهك – يا حواء – لم أعد أستطيع النظر فيه ، وكيف أنظر فيه وجبينك موصوم بعار المعصية ، وها هي تفاحتي ( تفاحة آدم ) عالقة في حلقي شاهداََ أزليا على ذلك الذنب العظيم الذي لم أكن لأرتكبه لو لم تغويني وتزيِّنِي لي عملي.
حاولتُ أن أجد مبررا واحدا لفعلتي أسترضي به ربي و أختلق الأعذار و المبررات الملفقة.
هكذا كنتُ قبل أن تخرجيني من جنتي فكيف سأكون ؟؟؟.
طردت من جنتي و شعرتُ – وقد أوصدتْ أبوابها خلفي – شعرت بالتشتت و الضياع و المهانة و الضعف ، أشياءُُ لم يسبق لي أن شعرتُ بها .
خرجتُ – يا حواء – من دار نعمتي و أنا أعلمها و أعرف عنها كل شيء ، إلى دارِِ تبعثُ على الهيبة و الخوف ، و كيف لا وقد نفض ربي يديه مني وتخلى عني .
وكان ربي عالما بما في نفسي تجاهكِ من التحفظ و النفور ، فآثر فوق عقابه لي أن يخلفني و حيدا لا سند لي.
و أصبحتْ تصفعني أكفُّ الوحشة أنَّى التفتُ أو اتجهت ، أرى من حولي فلا أجد إلا الفضاء يشعرني بالضاءلة و التقلص أمام اتساعه ، أصرخ فترتد إلي نبراتُ صوتي رجعُ صدى فتزيدني كآبة و انتفاضا.
عندما أنزلي ربي على الأرض جردني من كل شيء إلاّ من عقلي الحائر و أنفاسي المضطربة ، كانت هذه المشاعر الرهيبة – يا حواء – سببا كافيا لأعفو عنكِ وشفيعاََ لكِ عندي كفيلاََ بأن يجعلني أنسى ما أحس به من غيض نحوكِ بل و أكثر من ذلك تمنيتُ لو انكِ كنتِ إلى جانبي تؤنسينني و تشدين من أزري وبدون شعورِِ مني وجدتُني أبحث عنك من جديد كما كنتُ أفعلُ سلفاََ، إلا أنني لم أستطع إيجادكِ لجهلي بعالمي الجديد، ورغم ذلك لم أفقد الأمل في إيجادك لأني كنتُ أعلم بأنكِ في مكانِِ ما من جنتنا الأرضية المتواضعة ولم يكن جهلي بها ليجعلني أكفُ عن البحثِ عنكِ ، وكان بحثي عنكِ مفيداََ لي لأنه جعلني أدركُ حكمة ربي في إبعادكِ عني
فكنت في كل يوم أكتشف شيئا جديدا و أزدادُ أُنسا بما حولي من الموجودات و المخلوقات شيئا فشيئا ، حتى هدأت نفسي و عرف الاطمئنان طريقه إلى قلبي ، وتعودتُ على حياتي التي صرتُ إليها ، وعاد إلي الشعور بالملكية و أصبحتُ أعيش حياة الرتابة و السكون كما كنتُ أحياها في جنتي الأولى رغم الاختلاف الكبير بينهما وسلطة الزمن على الأشياء و ما يتوجبُ علي من إبداع وسائل العيش و أسبابه ، و السعي في كل ما أريد و تغير عاداتي الملكوتية إلى عادتِِ آدمية بحتة ، كل هذا حدث في غيابك ، ولا بد أنكِ قد عشتِ ما عشتُ ورأيتِ ما رأيتُ ولم نكن لندرك ذلك و نعلمه لو كنا معاََ لأننا ساعتها – مع ما تملكنا من هيبةِِ وشعورِِ بالعزلة و الخوف – كنا سنلزمُ مكاننا لا نبرحه أو نتجاوزه لاكتشاف ما حولنا ، هكذا كانت حكمة الخالق عزَّ و جلَّ ، كانت رحلة تأملِِ و تدبر أكثر منها رحلة بحث ، وكان البحث فيها عنكِ أمراََ ضرورياَ لأنك كل ما تبقى لي من تلك النعم التي كنتُ أنعم بها ، بل كنتِ النعمة الخالصة التي فرحتُ بها دون سائرِ النِعم ، فكان لزاما علي أن احفظ ما تبقى من أثرها.
هكذا كنتُ أراك رغم أنك أصل ما طرأ علي من نعمِِ في عالمي الجديد.
و ما كان ربي ليكلني إلى نفسي أكثر من ذلك ، فقد علم من ضعفي و قلة حيلتي ما يجعلني أحظى بتوبته عني
و أنا الذي استتبته و طلبتُ الصفح منه فتاب علي و أحاطني بفضله و رعايته ، فوفر علي عناء البحث عنكِ و جمع شملنا بعدما كدتُ أقطع الأمل في ذلك ، لنبدأ رحلتنا معا من جديد و تبدأ حياة البشر مسيرتها و نكون سبباََ لها و أصلاََ لكل فروعها .
قاسم عبد الرحمان
مسعد ولاية الجلفة
الجــــزائــــــــر
[center]
خطاب إلى حواء
كنتُ يا حواء – قبل أن تُخلقِي – ملكا في جنّتِي ، و ملكي لا حدود له ، ولا منازعَ ينازعني فيه ، وما كان مُلكي – على رحابته واتساعه – ليشعرني بالوحدة أو الوحشة ، بل كنتُ منعدم الشعور. فأنا لم أُحرمْ شيئا لأشعر بالحرمان ، ولم أنل شيئا كنتُ قد حُرِمتُه لأشعر بلذةِ ما حرمتُ منه ، فقد سبقت النِّعمُ خلْقي وبعد خلقي نلتُ كلّ شيء ، ولو قدِّر لي أن أشعر حينها لم أكن لأشعر بغير الأنس بالقرب ممن أسبل علي تلك النعم و وهبني تلك الجنة أتبوأُ منها حيثُ أشاء.
وحدي أسير وسط ذلك الملك العظيم أتقلبُ بين جناته وبساتينه ، أمدُّ يدي و لا أنظر إلى ما مددتُ له يدي لأنني كنتُ أعرف أن يدي أنَّى وقعتْ ستجني ثمراََ ولن ترتدَّ إلا بأطيب و أشهى الثمر ، ولم أكن أشفقُ أو أخشى على ما ستقطفه يدي الممتدة ، فقد تعودتُ أن تلك الثمار تثمرُ من جديد قبل أن تصل إلى فمي ، لأن الزمن - على أزليته واستمراره هناك – كان معدوما ولا سلطان له على جنتي.
وإن أحسستُ بالظمأ فما علي إلاّ أن أطأطئ لأشرب من أنهاري الجارية تحت قدمي وسيان عندي أشربتُ لبناََ أم ماءََ ، خمراََ أم عسلاََ ، فطعم اللبن كطعم الماء ، وطعم الخمر كالعسل ، ولأنني لم أكن أفكر في هذه الأشياء لوفرتها فقد كان شعوري فردوسياََ وتفكيري ملكوتياََ يتجاوز حدود الجنان و يصبو إلى عرش الرحمان.
كنتُ يا حواء – قبل أن تخرجيني من جنتي – أعيش كما أشتهي وبما يوافق هواي و يرضي مزاجي ، كانت حياتي مزاجية لا يعكر صفوها شيء ، بعيدة عن التفكير وحسابات النتائج و العواقب ، ليس هناك قانون يقيدني ويحدُّ من حريتي ، أو شريعةُُ تملي علي ما أفعل أو تفرض علي واجبات وتمنحني حقوقاََ ، بل لم تكن هناك محذورات ولا ممنوعات ، فكل شيء موجود هو جزءُُ من ملكي أتصرف فيه كيف أشاء دون رقيبِِ أو عتيد.
كانت جنّتي كاملةََ غير منقوصة ، وكان ملكي واسعاََ لا شيء ينقصة ، حتى الألحان لا أسمع إلاّ أشجاها وكل ما كان علي فعله هو الاستلقاء تحت أقرب شجرة مني و أصغي إلى طيور جنتي وهي تعزف أوتارها و تغني أعذب الألحان بأجمل الأصوات.
تعرفين يا حواء ؟ وسط كل هذا النعيم المقيم راودني ذات مرة شعورُُ غريب ، بأن شيئا ما ينقصني بم أكن أستطيع تحديده أو تسميته ، أقلبُ فكري لأعرف ماهية هذا الشيء و أدرك كنهه فأعود كليل الفكر عاجزاََ عن إدراكه.
ربما شعوري بالسلطة المطلقة جعلني أتساءل لو أن أحدا يشاركني هذا الملك و ينعم معي بهذا النعيم ، أكان سيجعلني أكثر سعادةََ أم يسلبني أشياء هي الآن ملكُ يميني ، وهل أن ما أملك هو كل شيء أم أن هناك أشياء أخرى أفضل لم أعطَها و لم أطلع عليها؟!.
أي رغبةِِ تلك التي تناديني و تجعلني أشعرُ بافتقاري لها رغم السعادة التي أتقلبُ فيها ؟!.
ظللتُ هكذا حتى تعبتُ و أنتفخ رأسي من كثرة الأسئلة إلى أن استولى علي النعاس فغفوتُ لبعض الوقت.
ولما فتحتُ عيني وجدتكِ إلى جانبي ؟ ! وبعفويةِِ غريزية هممتُ بكِ دون أن أحاول معرفة ما تكونين ، وكيف جئتِ ولم أكد أفعل حتى سمعتُ صوت ربي يناديني : توقف أبعد يدك ؟! .
فقلتُ: ولكن يا ربي لماذا تمنعني وأنت الذي وهبتني كل شيء ؟! أليس هذا بعضا من نعيمك الذي أتقلبُ فيه ؟!
قال: بلى ولكن هي لن تكون لك إلا بحقها.
قلتُ- وقد بدأتُ أشعر بما لم أكن أشعر به من قبل من المحذورات – وما حقها ؟!
قال: أن تشهد أن لا إله إلاّ الله و أن محمداََ رسول الله.
هنا عادت بي الذاكرة إلى ذلك اليوم الذي رأيت فيه اسم محمد على باب الجنة قبل أن أدخلها وقد كتب إلى جانب اسم الله مقروناََ به ، فتساءلتُ حينها : ولكن ما هذا الاسم الذي قرنته باسمك يا ربي ؟!
يومها أجابني قائلاََ: هذا أحد أبنائك و أكرمهم يجيء من ظهرك و نسبك.
فاستغربتُ و لم أدرك معنى ما قاله ، و كيف لي أن أدرك حينها و أنا مخلوق وحيد لم أر شيئاََ غيري إلا ما رأيتُ من الملإ الأعلى.
ولما ثبتُ إلى رشدي نطقتُ بالشهادتين ، وكان أول واجبِِ أقوم به منذ عرفتُ الحياة، وأبصرتْ عيني النور و أدركتُ ساعتها بأنكِ مخلوقُُ غير عادي وسيكون لي معك شأنُُ عظيم. كما أدركتُ مدى قداسة العلاقة التي ستربطنا ، - وكيف لا- وصداقها نطقُ الشهادتين بأجل و أعظم اسمين.
ثم تفقدتُ نفسي بعدما أحسستُ أنني قد فقدتُ بعضا مني و نظرتُ إلى جنبي الأيسر لأقف على كنهكِ وسر وجودك وأعرف سبب رغبتي فيك وميولي إليكِ وانعطافي نحوك.
منذ تلك اللحظة أصبحتُ لا أطيق الابتعاد عنكِ وكلما ابتعدتِ يضيق صدري و أشعر بالوحدة و الوحشة و ما كنت أشعر بهما من قبل ، وعندما أجدك يطمئن قلبي و تهدأ نفسي و أجد الراحة والأنس ، وكيف لا و أنت ذلك الضلع الذي قُدَّ مني ، ولطالما جاور قلبي و ارتوى بدمه فأخذ بعضا منه ، كيف لا و أنت جزء من كلّي ، والكل لا يتجزأ ، فلا عجب إذاََ أن أبحث عنكِ أو بالأحرى أبحث عن نفسي كلما فقدتك واشتق إليك في بعدي عنك و آنس بالقرب منك.
و ها أنت ذي - بعد أن أدركتِ ذلك – أصبحتِ تتعمدين الابتعاد عني والاختباء مني و كأنك تستمتعين بسعيي وراءك في جنتي على اتساعها و كثرة الأمكنة التي يمكن أن أجدك فيها . وكنت في كثير من الأحيان أفقد الأمل في العثور عليك ، ولكن ذلك لم يكن ليمنعني عن الاستمرار في البحث عنك حتى بعد مرور عدة أيام .
أصبحتِ شغلي الشاغل استحوذتِ على تفكيري وشعوري دون سائر النعم ، جعلتني – يا ضلعي الأعوج – أعرف معنى الوحدة و الوحشة عندما أفقدك و الأنس و السكينة حين أجدك.
أجبرتني على السعي من أجل تحصيل شيء ما و أنا الذي كنتُ أنال الأشياء دون سعي أو تعب ، أليس ذلك غريبا ؟! .
لا ، في الحقيقة لم أكن أستغرب ذلك.
لأنني عندما أقلبُ الأمور على وجوهها و أرجع الأسباب إلى المسببات أجد أنها محصِّلة معقولة و نتيجة حتمية لِما تقدم.
إنها - يا حواء- رحلة البحث عن الذّات أو بحث الكل المبتور عن الجزء المبتور منه ، أو ما نسميه اليوم ( النصف الآخر ) .
لكن الذي استغربه من كل هذا هو تساؤل الناس اليوم عن معنى الحب وسر وجوده و لماذا نشعر به ؟! و الإجابة من البساطة و السهولة ما يجعل هذا التساؤل سؤالا غبيا بل و أحمقاََ.
لأن الجزء المفقود - حتى و إن كان ضلعا أعوجا – فيكفي مبررا أنه قد أنتزع من جهة القلب الذي هو مستودع العواطف و مستقرها ، فلماذا إذاََ يتعبُ الخلق أنفسهم في فهم شيء من المسلمات كعاطفة الحب؟ ألا يعلمون أن كلا منهم شق مائل لا يستقيم إلا بالشق الآخر ، وأن جزءاََ منهم تجسد في مخلوق حي اسمه – حواء – و أودع أمانةََ في خلقها ؟!.
آدم يا حواء – الذي هو أنا – أو بالأحرى أنا – يا حواء – من أدرك سر علاقتنا لأنني يومها اشتهيتكِ و أردتكِ
و آدم اليوم يحبك و يهيم بكِ ، وشتان بين الاشتهاء و بين الحب.
و ها أنا الآن - مع بدأت أعانيه معكِ في جنتي – أصبحتُ أراك ذلك الضلع المتمرد عن أصله أو شهوة متمردة لتعود بي الذاكرة إلى ذلك اليوم المشهود – يوم خلقي – عندما أمر الله ملائكته أن يسجدوا لي ، ولم أكن ساعتها أعي شيئا مما يحدث حولي ، وكنتُ أشعر بأن شيئا عظيما يحدث.
سجد الملائكة كلهم إلا إبليس أبى، وحدث نقاش هو أقرب إلى الاختصام منه إلى الحوار ، لكن ما يجعله حوارا هو جلالة قدر الله بأنه الخالق و مهما علت درجة إبليس إلى الملائكية فإنه يبقى مخلوقا بأمر لا يعدو المسافة الفاصلة بين الكاف و النون.
لكنه لجهله نسي هذا الأمر و تطاول على خالقه الذي قال له كـــــــــــــــن ، فكان .
ولولا رفعةُ مكانتي و عظمة شأني ما كان ليحدث كل ذلك الحوار وتلك المجادلة ، و ما كان ربي ليقحم نفسه في خصامِِ من أجلي ؟!.
رجعت بي الذاكرة إلى تلك اللحظات الملكوتية العصيبة ، فلم أعد آبه لتمردك ، مادام ذلك المخلوق التافه التعيس – مع ما ناله من مكانةِِ عظيمة عند ربه – تمرد على خالقه - بعظمته وجلاله – و عصى أمره ، فكيف لا يتمرد ضلعُُ ( أعوج ) و شهوة وضيعة على صاحبها و جزء قليل على كله.
رغم كل ما حدث فإن الخالق تعالى وترفع عن ذلك المخلوق المسكين الذي لم يكن يعلم بأن الله خلقني لأكون سببا مقنعاََ لإخراجه من رحمته لما علمه من عدم صفاء سريرته و صدق طاعته الظاهرة ، فتركه على سجيته و أمهله إلى يوم القيامة لأنه يعلم بأنه سوف يأتي عليه يوم ويشعر بالندم و يتمنى لو أن ما حدث لم يحدث.
وفعلا فقد حدث ذلك ، إذ ورد في الأثر بأن إبليس طلب العفو من خالقه و أراد أن يتوب من ذنبه فتوسط لديه بأحد الأنبياء فاشترط عليه ربه أن ينفذ أمره و يسجد لي ، بعد مرور قرون عدة على خلقي ، لكنه – ولحمقه – رفض الأمر مجددا بقوله: إلاَّ هذا ؟! وبقي مصرا على ضلاله و معصيته.
فيا حواء....
يا ضلعي الأعوج: تمردي كما تشائين ، ويا شهوتي استبدي كما تريدين و يا جزئي تعالَيْ كما تحبين ، لأنك مهما تمردتِ فإلي تعودين ، ومهما استبديتِ ففي شهوتي تموتين ، ومهما تعاليتِ ففي كلي تذوبين.
فقد كنتُ أحيا و حياتي خلودا لا نهاية له ، وأنعم و كان نعيمي أزليا ، و كنتِ بعضا من ذلك النعيم أو ظننتكِ كذلك.
عندما كنتُ أبحث عنكِ كان يتملكني الخوف من أن يغويك ذلك المخلوق المتمرد ، لأن ربي لم يحذرني من تلك الشجرة عندما كنتُ وحدي ، ولم أعرف المحذورات إلا بعد ما أوجدكِ ، و كأنما قد أوجدها معكِ ، أو جعلك مصدرا لها و سببا للكثير منها ، وقبل كل شيء أصلها و مبدؤها، لأنه لا وجود لشيء قبل وجود أصل له و مبدء يبتدئ منه غير الله سبحانه و تعالى جل عن الشيئية.
ولن أنسى ذلك اليوم عندما وجدنك مع ذلك المخلوق و هو يزين لكِ الأكل من تلك الشجرة و يمنيك الأماني ، ولأن عقلي كان يبحث عن جديد يجعله يفهم أكثر و يستوعب ما حوله من الموجودات ، جعلتُ أتأمله و استمع لحديثه ، ولم أكن أعلم بما يبيته لنا.
لكن سلاسة لسانه وسحر بيانه – وهو المخلوق القديم صاحب الخبرة و الدهاء – غطى على بصيرتي و أدهش عقلي حتى كدتُ أميل إليه ، لولا تذكري لتحذير الخالق منه ، ولكنكِ يا حواء لم تشهدي ذلك اليوم العظيم – يوم السجود – يوم الملإ الأعلى إذ يختصمون . لذلك لم يكن لديك تحفظ من جهته ، فدخلتِ في غمرته ، ولفرط فضولي بدأتُ أتساءل عن سبب تحذير الخالق لنا من الشجرة التي لم أنتبه لوجودها من قبل ، إلا أنها أنها إحدى المحذورات التي عرفتها معكِ.
وكأن إبليس علم ما بنفسي ، فلم يفوت تلك الفرصة لينصب لي كمينه بقوله: (( مَا مَنَعَكُمَا رَبُّكُمَا مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخَالِدِينَ )). صدق الله العظيم
هنا طار لبُّكِ وذهب عقلك و غابت عنك الحكمة و خانتك البصيرة ، فمددتِ يدك و تناولتِ تفاحة و أكلتِها بكل برودة ، وأردتِ أن أشاركك أكلها فأغريتني بحلاوة طعمها و لذة مذاقها . و لم أكد أبتلعها حتى سمعتُ صوت ربي يناديني فأفقتُ مذعوراََ وأنا لم أبتلعها بعد.
مر علي يوم عانيتُ فيه لحظات عصيبة ما زالتْ صورتها في نفسي ، والندم عليها يأكلني حتى اليوم، وعارها يطاردني في يقظتي و منامي ، وعندما أتذكرها أرى نظرات ربي الغاضبة و سحنته المتجهمة ، وسرائر إبليس المبتهجة المليئة بنظرات البِشرِ و الاستهزاء ، و فرحة الظفرِ و الانتصار.
حتى وجهك – يا حواء – لم أعد أستطيع النظر فيه ، وكيف أنظر فيه وجبينك موصوم بعار المعصية ، وها هي تفاحتي ( تفاحة آدم ) عالقة في حلقي شاهداََ أزليا على ذلك الذنب العظيم الذي لم أكن لأرتكبه لو لم تغويني وتزيِّنِي لي عملي.
حاولتُ أن أجد مبررا واحدا لفعلتي أسترضي به ربي و أختلق الأعذار و المبررات الملفقة.
هكذا كنتُ قبل أن تخرجيني من جنتي فكيف سأكون ؟؟؟.
طردت من جنتي و شعرتُ – وقد أوصدتْ أبوابها خلفي – شعرت بالتشتت و الضياع و المهانة و الضعف ، أشياءُُ لم يسبق لي أن شعرتُ بها .
خرجتُ – يا حواء – من دار نعمتي و أنا أعلمها و أعرف عنها كل شيء ، إلى دارِِ تبعثُ على الهيبة و الخوف ، و كيف لا وقد نفض ربي يديه مني وتخلى عني .
وكان ربي عالما بما في نفسي تجاهكِ من التحفظ و النفور ، فآثر فوق عقابه لي أن يخلفني و حيدا لا سند لي.
و أصبحتْ تصفعني أكفُّ الوحشة أنَّى التفتُ أو اتجهت ، أرى من حولي فلا أجد إلا الفضاء يشعرني بالضاءلة و التقلص أمام اتساعه ، أصرخ فترتد إلي نبراتُ صوتي رجعُ صدى فتزيدني كآبة و انتفاضا.
عندما أنزلي ربي على الأرض جردني من كل شيء إلاّ من عقلي الحائر و أنفاسي المضطربة ، كانت هذه المشاعر الرهيبة – يا حواء – سببا كافيا لأعفو عنكِ وشفيعاََ لكِ عندي كفيلاََ بأن يجعلني أنسى ما أحس به من غيض نحوكِ بل و أكثر من ذلك تمنيتُ لو انكِ كنتِ إلى جانبي تؤنسينني و تشدين من أزري وبدون شعورِِ مني وجدتُني أبحث عنك من جديد كما كنتُ أفعلُ سلفاََ، إلا أنني لم أستطع إيجادكِ لجهلي بعالمي الجديد، ورغم ذلك لم أفقد الأمل في إيجادك لأني كنتُ أعلم بأنكِ في مكانِِ ما من جنتنا الأرضية المتواضعة ولم يكن جهلي بها ليجعلني أكفُ عن البحثِ عنكِ ، وكان بحثي عنكِ مفيداََ لي لأنه جعلني أدركُ حكمة ربي في إبعادكِ عني
فكنت في كل يوم أكتشف شيئا جديدا و أزدادُ أُنسا بما حولي من الموجودات و المخلوقات شيئا فشيئا ، حتى هدأت نفسي و عرف الاطمئنان طريقه إلى قلبي ، وتعودتُ على حياتي التي صرتُ إليها ، وعاد إلي الشعور بالملكية و أصبحتُ أعيش حياة الرتابة و السكون كما كنتُ أحياها في جنتي الأولى رغم الاختلاف الكبير بينهما وسلطة الزمن على الأشياء و ما يتوجبُ علي من إبداع وسائل العيش و أسبابه ، و السعي في كل ما أريد و تغير عاداتي الملكوتية إلى عادتِِ آدمية بحتة ، كل هذا حدث في غيابك ، ولا بد أنكِ قد عشتِ ما عشتُ ورأيتِ ما رأيتُ ولم نكن لندرك ذلك و نعلمه لو كنا معاََ لأننا ساعتها – مع ما تملكنا من هيبةِِ وشعورِِ بالعزلة و الخوف – كنا سنلزمُ مكاننا لا نبرحه أو نتجاوزه لاكتشاف ما حولنا ، هكذا كانت حكمة الخالق عزَّ و جلَّ ، كانت رحلة تأملِِ و تدبر أكثر منها رحلة بحث ، وكان البحث فيها عنكِ أمراََ ضرورياَ لأنك كل ما تبقى لي من تلك النعم التي كنتُ أنعم بها ، بل كنتِ النعمة الخالصة التي فرحتُ بها دون سائرِ النِعم ، فكان لزاما علي أن احفظ ما تبقى من أثرها.
هكذا كنتُ أراك رغم أنك أصل ما طرأ علي من نعمِِ في عالمي الجديد.
و ما كان ربي ليكلني إلى نفسي أكثر من ذلك ، فقد علم من ضعفي و قلة حيلتي ما يجعلني أحظى بتوبته عني
و أنا الذي استتبته و طلبتُ الصفح منه فتاب علي و أحاطني بفضله و رعايته ، فوفر علي عناء البحث عنكِ و جمع شملنا بعدما كدتُ أقطع الأمل في ذلك ، لنبدأ رحلتنا معا من جديد و تبدأ حياة البشر مسيرتها و نكون سبباََ لها و أصلاََ لكل فروعها .
قاسم عبد الرحمان
مسعد ولاية الجلفة
الجــــزائــــــــر
[center]





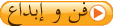
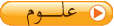












 من طرف عبد الرحمان 1 الثلاثاء يونيو 17, 2008 2:37 pm
من طرف عبد الرحمان 1 الثلاثاء يونيو 17, 2008 2:37 pm






