للأستاذ أحمد حسن الزَيَّات
(1885-1968م)
نحن الآن في مطلع القرن الحادي والعشرين...من هنا تأتي طرافة أن نتعرف إلى جانب من جوانب حياتنا الاجتماعية في آخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين عبر هذا النص، الذي يجلو لنا فيه الأديب اللامع صاحب مجلة الرسالة "أحمد حسن الزيات" طرفًا من لوحة الاحتفال بالعيد في القرية.. بأسلوبه الرفيع ، ولغته الصافية المترقرقة، وبيانه "المهندس"..يقول الزيات:
عيد الأضحى.. هو عيد الأسرة والأمة والملة. يُفيْض المَسرَّة والبهجة على البيت، ويجدد المودة والألفة في الوطن، ويُسْفِر بالتعارف بين وجوه الأخوة في عرفات.
فإذا رده اليوم فساد العيش في المدينة إلى ما نعرف.. فإن له في القرية صورة –لاتزال- منذ الطفولة- في ذهني: فتانة الجمال.. أخاذة السحر.. شديدة الروعة.
لا يكاد القرويون يفرغون من صلاة المغرب ليلة العيد حتى ترى طريق المقبرة يسيل بالفوانيس الشاحبة الخافتة، ثم تنتشر آخر الأمر على وجوه المقابر انتشار الحباحب (ذباب يطير بالليل، له شعاع في ذنبه كالسراج).. وتنتقل القرية الحية إلى القرية الميتة، فتقضي الليل في الاستعبار والاستذكار والقراءة، ثم يعودون وقد كفاهم "الفقهاء" (الفقيه لقب كان يطلقه الناس على قارئ القرآن في المقابر) مئونة ما حملوا من الكعك والفاكهة.. فيقطعون الهزيع الثاني من الليل في طسوت الحمام أو في دار المزين.. والاغتسال بالماء الساخن؛ لا يعرفه الفلاحون إلا ليلة العيد، وليلة الزواج، ويوم الموات!.
ثم يُعدُّون زينة العيد.. فيكوِّرون العمائم، ويصبغون الأحذية. ومن لا يحسن لَوْي العمامة، أو لا يملك علبة "الورنيش"؛ ذهب بطربوشه أو حذائه إلى قريبه وجاره. والقرية كلها أسرة واحدة.. يكمل بعضها نقص بعض. فإذا فرغوا من ذلك ناموا على هدهدة الأحلام، ومناغاة المُنَى، وتركوا النساء أمام الكوانين: يُنْضِجن الخبز، ويُطهُون اللحم، ويصنعن "الحلو" حتى الصباح.
تشرق شمس العيد على القرية في غير وجهها المألوف.. فلا النور كان باهرًا كهذا النور، ولا الشعاع كان ساحرًا كهذا الشعاع.
وتستقبلها القرية في غير زِيِّها المعروف.. فلا الوجوه كانت ضاحكة كهذه الوجوه، ولا "الجلابيب" كانت ناصعة كهذه الجلابيب، ولا "العمائم" كانت زُهْرًا كهذه العمائم، ولا الأزقة كانت مطرزة بألوان الربيع كما هي اليوم (إشارة إلى "جلابيب" الأطفال الجديدة المختلفة الألوان).
لا يتخلَّف عن صلاة العيد من أهل القرية غير النساء. أما الرجال.. فهم صفوف وراء الإمام يؤدون الصلاة. وأما الأطفال.. فهم وقوف على الأبواب يشهدون الخطبة.
ثم تُقْضَى الصلاة.. فيُقَبِّلون الإمام جميعًا، ويُقبِّل بعضهم بعضًا، ثم يذهبون رَتْلاً جميل النسق إلى المقبرة، ويرجعون من طريق آخر إلى الحارات المكنوسة المفروشة، فيجلسون أمام المنازل إلى الطعام الشهي الفاخر، يتبادلون الألوان (أصناف الطعام)، ويتهادون الصِّحاف، ويتركون على موائدهم محلاًّ رحيبًا للفقراء.
ترفع "الصواني"، وتوضع القهوة.. ثم يقوم "العمدة" في أهل حارته، فيزورون الحارة الأولى، فيهنئون ويجلسون ريثما تدار "القزمة" وتوزع "السكائر".. ثم يقومون جميعًا إلى الحارة الثانية، فالثالثة، فالرابعة.. وهلمَّ جرًّا.. إلى آخر البلد. وكلما مروا بحارة صحبهم أهلها إلى الأخرى، حتى تجتمع القرية كلها آخر المطاف لدى "العمدة"، فيقضون في مجلسه أكثر اليوم.
ذلك أمر الكهول والشيوخ.. أما الشباب والأيفاع.. فيطوفون زمرًا بالبيوت، يهنئون الصبايا وأيديهن لاتزال في الطعام، فيطبعن بالقبلات الخليَّة على الخدود البُرنْزيَّة خاتمًا رفيقًا من "الصلصة"، ويرسمن بالأنامل المخضبة على الثياب البيض طَغْراء "علامة" جميلة من الدسم.
ثم ينصرف بعد ذلك الشباب إلى لعب الكرة في ساحة الجُرْن، ويذهب الأطفال إلى الأراجيح على أشجار التِّرعة.
تلك كانت صورة العيد في القرية.. رسمتُها بغير ألوانها الزاهية، وجلوتها في غير إطارها المذهب.
فبالله ربك.. أهي –على عِلاتِها- أَخْلَق بالإنسان، وأقرب إلى الدِّيْن، وأشبه بالخُلُق –أم هذه الصورة التي تراها اليوم في شوارع المدينة.. وجوامع المدينة.. وفصول المدينة؟!
نسأل الله -عزوجل - مخلصين أن يعيد هذا العيد على الأمة المصرية والدول العربية والممالك الإسلامية .. ونحن وهم على خير من هذه الحال.
--------------------------------------------------------------------------------
[نشر المقال في مجلة "الرسالة" عدد 26 مارس 1934]
(1885-1968م)
نحن الآن في مطلع القرن الحادي والعشرين...من هنا تأتي طرافة أن نتعرف إلى جانب من جوانب حياتنا الاجتماعية في آخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين عبر هذا النص، الذي يجلو لنا فيه الأديب اللامع صاحب مجلة الرسالة "أحمد حسن الزيات" طرفًا من لوحة الاحتفال بالعيد في القرية.. بأسلوبه الرفيع ، ولغته الصافية المترقرقة، وبيانه "المهندس"..يقول الزيات:
عيد الأضحى.. هو عيد الأسرة والأمة والملة. يُفيْض المَسرَّة والبهجة على البيت، ويجدد المودة والألفة في الوطن، ويُسْفِر بالتعارف بين وجوه الأخوة في عرفات.
فإذا رده اليوم فساد العيش في المدينة إلى ما نعرف.. فإن له في القرية صورة –لاتزال- منذ الطفولة- في ذهني: فتانة الجمال.. أخاذة السحر.. شديدة الروعة.
لا يكاد القرويون يفرغون من صلاة المغرب ليلة العيد حتى ترى طريق المقبرة يسيل بالفوانيس الشاحبة الخافتة، ثم تنتشر آخر الأمر على وجوه المقابر انتشار الحباحب (ذباب يطير بالليل، له شعاع في ذنبه كالسراج).. وتنتقل القرية الحية إلى القرية الميتة، فتقضي الليل في الاستعبار والاستذكار والقراءة، ثم يعودون وقد كفاهم "الفقهاء" (الفقيه لقب كان يطلقه الناس على قارئ القرآن في المقابر) مئونة ما حملوا من الكعك والفاكهة.. فيقطعون الهزيع الثاني من الليل في طسوت الحمام أو في دار المزين.. والاغتسال بالماء الساخن؛ لا يعرفه الفلاحون إلا ليلة العيد، وليلة الزواج، ويوم الموات!.
ثم يُعدُّون زينة العيد.. فيكوِّرون العمائم، ويصبغون الأحذية. ومن لا يحسن لَوْي العمامة، أو لا يملك علبة "الورنيش"؛ ذهب بطربوشه أو حذائه إلى قريبه وجاره. والقرية كلها أسرة واحدة.. يكمل بعضها نقص بعض. فإذا فرغوا من ذلك ناموا على هدهدة الأحلام، ومناغاة المُنَى، وتركوا النساء أمام الكوانين: يُنْضِجن الخبز، ويُطهُون اللحم، ويصنعن "الحلو" حتى الصباح.
تشرق شمس العيد على القرية في غير وجهها المألوف.. فلا النور كان باهرًا كهذا النور، ولا الشعاع كان ساحرًا كهذا الشعاع.
وتستقبلها القرية في غير زِيِّها المعروف.. فلا الوجوه كانت ضاحكة كهذه الوجوه، ولا "الجلابيب" كانت ناصعة كهذه الجلابيب، ولا "العمائم" كانت زُهْرًا كهذه العمائم، ولا الأزقة كانت مطرزة بألوان الربيع كما هي اليوم (إشارة إلى "جلابيب" الأطفال الجديدة المختلفة الألوان).
لا يتخلَّف عن صلاة العيد من أهل القرية غير النساء. أما الرجال.. فهم صفوف وراء الإمام يؤدون الصلاة. وأما الأطفال.. فهم وقوف على الأبواب يشهدون الخطبة.
ثم تُقْضَى الصلاة.. فيُقَبِّلون الإمام جميعًا، ويُقبِّل بعضهم بعضًا، ثم يذهبون رَتْلاً جميل النسق إلى المقبرة، ويرجعون من طريق آخر إلى الحارات المكنوسة المفروشة، فيجلسون أمام المنازل إلى الطعام الشهي الفاخر، يتبادلون الألوان (أصناف الطعام)، ويتهادون الصِّحاف، ويتركون على موائدهم محلاًّ رحيبًا للفقراء.
ترفع "الصواني"، وتوضع القهوة.. ثم يقوم "العمدة" في أهل حارته، فيزورون الحارة الأولى، فيهنئون ويجلسون ريثما تدار "القزمة" وتوزع "السكائر".. ثم يقومون جميعًا إلى الحارة الثانية، فالثالثة، فالرابعة.. وهلمَّ جرًّا.. إلى آخر البلد. وكلما مروا بحارة صحبهم أهلها إلى الأخرى، حتى تجتمع القرية كلها آخر المطاف لدى "العمدة"، فيقضون في مجلسه أكثر اليوم.
ذلك أمر الكهول والشيوخ.. أما الشباب والأيفاع.. فيطوفون زمرًا بالبيوت، يهنئون الصبايا وأيديهن لاتزال في الطعام، فيطبعن بالقبلات الخليَّة على الخدود البُرنْزيَّة خاتمًا رفيقًا من "الصلصة"، ويرسمن بالأنامل المخضبة على الثياب البيض طَغْراء "علامة" جميلة من الدسم.
ثم ينصرف بعد ذلك الشباب إلى لعب الكرة في ساحة الجُرْن، ويذهب الأطفال إلى الأراجيح على أشجار التِّرعة.
تلك كانت صورة العيد في القرية.. رسمتُها بغير ألوانها الزاهية، وجلوتها في غير إطارها المذهب.
فبالله ربك.. أهي –على عِلاتِها- أَخْلَق بالإنسان، وأقرب إلى الدِّيْن، وأشبه بالخُلُق –أم هذه الصورة التي تراها اليوم في شوارع المدينة.. وجوامع المدينة.. وفصول المدينة؟!
نسأل الله -عزوجل - مخلصين أن يعيد هذا العيد على الأمة المصرية والدول العربية والممالك الإسلامية .. ونحن وهم على خير من هذه الحال.
--------------------------------------------------------------------------------
[نشر المقال في مجلة "الرسالة" عدد 26 مارس 1934]





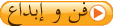
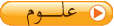











 من طرف
من طرف 
